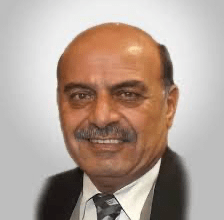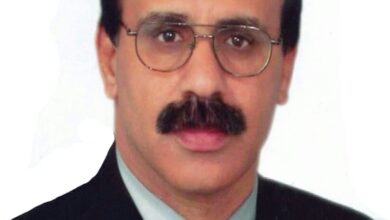أزمة الأنقاض في مدن وقرى المملكة: خطر بيئي وحضاري يتطلب حلولًا عاجلة

كتب أ.د. محمد الفرجات
أصبحت ظاهرة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم في أحياء مدن وقرى المملكة واحدة من القضايا البيئية والاجتماعية المؤرقة، حيث تتفاقم دون حلول جذرية أو تنظيم فعال.
ففي ظل توسع عمليات الإعمار والصيانة، يلجأ الكثير من أصحاب العقارات أو الأهالي إلى التخلص من الأنقاض بطرق مخالفة وغير مسؤولة، غالبًا عبر سكبها في الأودية، والساحات العامة، وحتى على جوانب الطرق.
الآثار البيئية والصحية:
لا تتوقف خطورة الظاهرة عند تشويه المنظر العام فحسب، بل تمتد إلى أضرار بالغة على:
التربة: بفعل المواد غير القابلة للتحلل ومواد البناء الثقيلة التي تغير من خواصها.
المياه السطحية ومجاريها: حيث تعيق جريان المياه وتزيد من احتمالات الفيضانات.
المياه الجوفية: إذ تتسرب الملوثات والمعادن السامة إليها بمرور الوقت.
الغطاء الأخضر والتنوع الحيوي: نتيجة طمر النباتات وقتل الموائل الطبيعية للكائنات الحية.
غياب التنظيم والرقابة:
تتفاقم الظاهرة في ظل غياب مكاب أنقاض معتمدة ومنظمة، الأمر الذي يترك المجال مفتوحًا للتصرفات الفردية والعشوائية. والأسوأ أن بعض سواقين القلابات يتعمدون التخلص من الحمولة بطرق غير قانونية لتحقيق الربح السريع.
الأدهى أن بعض السلطات المحلية نفسها لجأت إلى سكب الأنقاض بشكل عشوائي بحجة عدم توفر البدائل، وهو ما يفقدها المصداقية ويقوّض الثقة بينها وبين المواطنين.
انعكاسات حضارية واقتصادية:
هذه الفوضى العمرانية لا تسيء للبيئة فقط، بل تنعكس على:
المنظر العام للمدن والقرى، مما يعطي صورة سلبية وغير حضارية.
القطاع السياحي: فالزائر لا يمكن أن ينجذب إلى مواقع تحيطها مكبات عشوائية للأنقاض.
الاستثمار: إذ يرى المستثمرون في هذه المشاهد انعكاسًا لغياب الأنظمة والرقابة، ما يضعف جاذبية البيئة الاستثمارية.
غياب القوانين الشاملة:
على الرغم من وجود تعليمات عامة، إلا أن غياب قانون شامل ومنظم لإدارة مخلفات البناء والهدم يجعل الرقابة ضعيفة والالتزام شبه معدوم، ما يزيد من تفاقم الظاهرة وآثارها السلبية.
تجربة ألمانيا في تنظيم إدارة الأنقاض:
تُعد ألمانيا من الدول الرائدة عالميًا في إدارة مخلفات البناء والهدم، حيث وضعت أنظمة صارمة ومتكاملة منذ عقود، ونجحت في تحويل المشكلة إلى فرصة اقتصادية وبيئية. يمكن تلخيص التجربة الألمانية في النقاط التالية:
1. القوانين الصارمة: يخضع كل مشروع بناء أو هدم لقوانين ملزمة تحدد كيفية جمع، فرز، ونقل الأنقاض، مع فرض غرامات عالية على أي مخالفات.
2. مكاب ومعامل متخصصة: يتم نقل الأنقاض إلى مواقع معتمدة ومؤهلة بيئيًا، حيث تُفرز المخلفات إلى فئات: (خرسانة، معادن، خشب، بلاستيك، زجاج، تربة…).
3. إعادة التدوير بنسبة مرتفعة: أكثر من 90% من مخلفات البناء والهدم في ألمانيا يعاد تدويرها. الخرسانة تُطحن وتستخدم في رصف الطرق أو كمواد بناء، المعادن يعاد صهرها، والخشب يُوظف في صناعات مختلفة أو لإنتاج الطاقة الحيوية.
4. التكنولوجيا والرقابة: تُستخدم أنظمة تتبع رقمية (GPS) لسائقي الشاحنات لضمان تفريغ الحمولة في المواقع المصرح بها فقط. كما تُراقب البلديات العملية خطوة بخطوة، بدءًا من منح رخصة الهدم أو البناء وحتى التخلص من آخر شاحنة أنقاض.
5. الشراكة مع القطاع الخاص: تشجع الحكومة شركات متخصصة على الاستثمار في معامل إعادة التدوير، وتمنحها حوافز مالية وضريبية.
6. ثقافة مجتمعية واعية: يلتزم المواطنون والشركات بالقوانين باعتبار إدارة المخلفات جزءًا من الثقافة البيئية العامة، وهو ما يعزز نجاح النظام.
الدروس المستفادة للأردن:
تجربة ألمانيا تقدم مثالًا يمكن الاستفادة منه محليًا، من خلال:
تشريع قوانين واضحة وملزمة كما هو الحال في ألمانيا.
إنشاء محطات فرز ومعالجة معتمدة في كل محافظة.
الاستفادة من تقنيات التتبع والرقمنة في ضبط النقل والتفريغ.
تحويل الأنقاض من عبء إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة التدوير.
مقترحات للحلول:
لمعالجة هذه القضية المزمنة، لا بد من خطة وطنية متكاملة تتضمن:
1. إنشاء مكاب مركزية معتمدة في كل محافظة أو لواء، مهيأة بيئيًا لاستقبال ومعالجة الأنقاض.
2. إقرار تشريعات واضحة وملزمة لإدارة مخلفات البناء والهدم، مع تحديد الغرامات والعقوبات بصرامة.
3. رقمنة عملية النقل والتخلص عبر تراخيص إلكترونية لسائقي القلابات، وربطها بآليات تتبع GPS لضمان الالتزام بمواقع التفريغ المعتمدة.
4. إعادة التدوير والاستفادة: تشجيع الاستثمار في إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها في ردم الشوارع أو إنتاج مواد بناء بديلة.
5. حملات توعية مجتمعية موجهة للأهالي وأصحاب العقارات حول مخاطر التخلص العشوائي وفوائد الالتزام.
6. شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مكابس ومحطات فرز ومعالجة، بما يسهم في خلق فرص عمل خضراء.
7. تعزيز الرقابة المحلية وتفعيل دور البلديات كجهات تنفيذية ورقابية في آن واحد.
إن استمرار ظاهرة الأنقاض العشوائية يشكل خطرًا بيئيًا وحضاريًا واقتصاديًا متصاعدًا. ولا يمكن للمملكة أن تسعى نحو مستقبل أكثر استدامة وجاذبية للسياحة والاستثمار ما لم يتم وضع حد لهذه الممارسات من خلال تشريعات حازمة، وبنية تحتية ملائمة، ورقابة فاعلة، وتوعية مجتمعية. الحلول موجودة، وتجربة ألمانيا دليل على أن الإدارة الناجحة ممكنة، ويبقى التنفيذ هو التحدي الأكبر.