هشام حرب .. فلسطيني عالق بين الاعتقال التعسفي ووعد عباس بتسليمه الى فرنسا
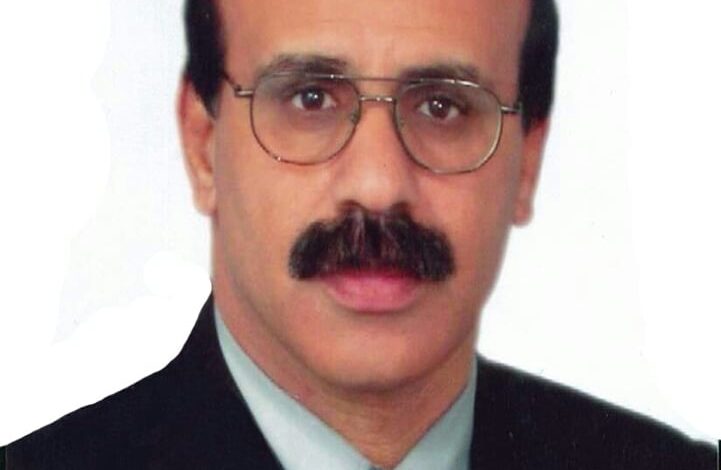
مهدي مبارك عبد الله
قبل أن نغوص في تفاصيل الملف السياسي والقانوني لا بد من توضيح أمر حاسم هذا المقال لا يبرّر أي عمليات قتل أو أعمال دموية ارتكبها هشام حرب أو أي من أعضاء جماعة أبو نضال ونحن لا ندافع هنا عن أي تصفية ولا أي هجمات دموية استهدفت فلسطينيين أو شخصيات عامة في أي بلد ولا نغطي على أي تجاوزات ارتكبها أفراد تحت أي ذريعة سياسية أو انتقامية وان أي محاولة لتقديم هذه العمليات كنموذج أو قدوة للمستقبل هي خارجة تمامًا عن سياق هذا المقال
ما يهمنا في هذا المقال هو البعد الإنساني والوطنية الضمنية للموقف الحالي لرجل فلسطيني كان فدائي ومناضل ومقاتل ورجل أمن سابق داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية ويعيش حالة صحية حرجة ويواجه إجراءات اعتقال تعسفي وتسليم خارج اطار أي مسوغ قانوني أو إنساني وهذا محور النقاش وهو ما يشكّل الخط الأحمر للقضية الوطنية والحقوقية، بعيدًا عن أي تبرير لأفعال سابقة ارتكبها الرجل أو جماعته
الإرهاب الصهيوني لم يكن يومًا ظاهرة عابرة يصنعها مستوطن حاقد أو جندي متغطرس على حاجز امني، بل هو جذر مسموم امتدّ من لحظة الانتداب إلى لحظة قيام الدولة، وتضاعفت سكاكينه كلما صمت العالم. من دير ياسين إلى قبية، ومن اللد إلى كفر قاسم، ومن صبرا وشاتيلا إلى أحياء غزة واليوم، يخرج القتلة من المشهد بتواقيع الجنرالات ورعاية الحكومات، وكأن الدم الفلسطيني وُلد ليُسفك بلا محاسبة. وقادة العصابات الذين أشعلوا أدوات التفجير في فندق الملك داود، والذين رفعوا رايات شتيرن والإرغون فوق جثث القرى المحروقة، أصبحوا رؤساء حكومات ووزراء دفاع وصنّاع سياسات، بينما دفنت المذكرات البريطانية والدولية التي صدرت بحقهم تحت أقدام المصالح الاستعمارية. وعندما تحوّلت الدولة إلى جيش منظم، دخل شارون وديان وباراك وشامير وغيرهم التاريخ بأوسمة رسمية، رغم أن دفاتر جرائمهم تكفي لإدانة أمة كاملة لو وُجد قضاء يمتلك ذرة نزاهة وجرأة.
اليوم، ومع أنّ المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو ويواف غالانت ، إلا أن السؤال ليس في وجود المذكرة، بل في إمكانية تنفيذها. ومن يملك الجرأة على لمس رئيس وزراء الاحتلال؟ من يوقفه عن طائرته؟ ومن يضعه في سيارة ترحيل؟ ومن يطبّق القانون على من تعتبره الدول الكبرى شريكها الاستراتيجي؟ إن هذا السؤال وحده يكشف حقيقة النظام العالمي حين يرفع القانون كشعار، لكنّه يُدفن عندما تقترب حدوده من إسرائيل. والسؤال الأكثر إحراجًا لو زار نتنياهو رام الله، هل يجرؤ محمود عباس على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية كما تعهّد مرارًا ؟ الإجابة يعرفها الفلسطيني قبل أن تُطرح، لأن السلطة التي تبني حضورها على التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين والمناضلين لا تحتمل فكرة أن ترفع إصبعًا على اي مسؤول او مستوطن إسرائيلي مهما ارتكب من جرائم وحشية .
في وسط هذا العالم المقلوب، تتجه السلطة الفلسطينية لتسليم مناضل فلسطيني إلى دولة أجنبية، في أوّل سابقة من نوعها منذ نشأتها، وكأنّها تعيد تعريف مهمتها: ليست حماية أبناء شعبها، بل إثبات حسن السلوك أمام دولة أوروبية تبحث عن إغلاق ملف عمره أربعة عقود. محمود عباس أعلن في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن إجراءات تسليم هشام حرب وصلت إلى مراحلها النهائية، في توقيت يثير كل الشبهات، لأنه جاء بعد اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية وحزمة من التفاهمات السياسية التي فتحت شهية باريس لإحياء ملف قديم تحوّل فجأة إلى اختبار للعلاقات الثنائية.
القضية هنا ليست مجرد ملف قضائي، بل مشهد سياسي كامل يعرّي السلطة من رأسها حتى قدميها. هشام حرب ليس مجرمًا فارًا ولا لصًا ولا مافيويًا، بل مناضل فلسطيني خاض ضمن ظروف معقدة ومشحونة تاريخيًا، وارتبط اسمه بمرحلة من العنف السياسي الذي عرفته المنطقة والعالم. الاسم الذي يعرفه الفرنسيون من أرشيف التحقيقات هو “هشام حرب”، لكنه في الحقيقة محمود خضر عابد العدرة، ابن بلدة يطا جنوب الخليل، رجل عرف العمل الفدائي بقدر ما عرف السجون والسرية والتنقل، قبل أن يعود إلى حياة هادئة في أجهزة السلطة التي خدم فيها حتى التقاعد.
فرنسا تتّهم الرجل بقدرته على الإشراف على العملية التي استهدفت مطعم “جو جولدنبرغ” في الحي اليهودي بباريس في 9 أغسطس 1982، وهي عملية بدأها مهاجم بإلقاء قنبلة يدوية داخل المطعم المزدحم بنحو 50 زبونًا، ثم اقتحم رجلان يحملان رشاشَي WZ-63 المكان، فقتلوا ستة وأصابوا اثنين وعشرين. التحقيقات الفرنسية التي أعيد فتحها لاحقًا ربطت العملية بفصيل “فتح – المجلس الثوري”، تنظيم أبو نضال المعروف بحضوره الدولي وعملياته الواسعة التي امتدت إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، والذي أشعل اسمه عواصم العالم في السبعينيات والثمانينيات.
ملف العملية ظلّ مُجمّدًا لفترة طويلة، حتى ظهر سلاح داخل أحد المتنزهات الباريسية يشتبه بأنه استُخدم في الهجوم، فعاد القاضي الفرنسي مارك تريفيديك لفتح القضية عام 2007. ومن خلال شهادتين سريتين لعضوين سابقين في منظمة أبو نضال، معروفين بالرمزين 93 و107، قال الاثنان إن هشام حرب كان قائد المجموعة على الأرض والمشرف المباشر على التنفيذ. وحتى أحد الناجين، شابٌ كان في السادسة عشرة من عمره يومها، قال إنه رآه أثناء إطلاق النار. لكن كل هذه الشهادات تظلّ في إطار الرواية الفرنسية، التي لا يمكن اعتبارها حقيقة مطلقة أو نهائية في عالم تداخلت فيه السياسة مع التحقيقات الأمنية في كل عملية فدائية خارج الحدود.
ما حدث بعد العملية أن هشام حرب غادر فرنسا، متنقلًا بين عواصم عربية عاشت فيها التنظيمات الفلسطينية فصولًا معقدة من العمل السري، ثم انتهى به المطاف إلى قطاع غزة بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994. ومن هناك إلى رام الله، حيث بقي بعيدًا عن العلن، يتنقل بين عمله داخل الأجهزة الأمنية وحياته اليومية، إلى أن خرج من الخدمة برتبة عقيد واستقرّ في بيته كأي رجل في سنواته الأخيرة يريد أن يعيش ما تبقى من عمره بهدوء.
مع اتصال فرنسي رسمي بالسلطة عاد الملف إلى سطح العلاقات الثنائية، خصوصًا بعد أن أصدرت باريس عام 2015 مذكرة توقيف دولية بحق حرب وثلاثة آخرين، بينهم زهير العباسي المعروف بـ“أمجد عطا”، ووليد أبو زيد المعروف بـ“سهيل عثمان”. الأردن أوقف الأول ورفضت طلب التسليم كونه يجمل الجنسية الاردنية ثم أفرج عنه بكفالة، والنرويج اعتقلت الآخر ثم دخلت معه في مسار قانوني انتهى بإطلاق سراحه، وجميع الدول رفضت تسليم أيّ من هؤلاء إلى فرنسا، لأنها تدرك حساسية الملفات السياسية المرتبطة بالتاريخ الفلسطيني المسلح. الدول لم تتجرأ على التسليم. لكن السلطة الفلسطينية، الدولة على الورق والتي لم تُعلن استقلالًا كاملًا ولم تتحرر بعد، قررت أن تفعل ما لم يفعله أحد من قبل.
في سبتمبر 2025 أعلنت النيابة الفرنسية أن السلطة أوقفت هشام حرب رسميًا، تزامنًا مريبًا مع قرب إعلان باريس الاعتراف بدولة فلسطين. الإليزيه قال علنًا إنه لا توجد مشكلة قانونية في التسليم، وإن ما يجري هو مجرد ترتيبات تقنية، بينما ماكرون وصف تعاون السلطة بـ“الممتاز”. هكذا تتحول قضية عمرها أكثر من أربعة عقود إلى ورقة سياسية تُلوّح بها باريس، وتلتقطها رام الله بلا تردد، وكأن السلطة تسابق الزمن كي تقدم ما يثبت أنها “جديرة بالثقة” على حساب مواطن فلسطيني لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه دون ألم.
عائلة حرب خرجت مؤخرا ببيان لم يحمل لغة سياسية، بل مشاعر الخوف. قالت فيه إن ابنها يعاني من أمراض خطيرة، أبرزها سرطان المثانة وأمراض القلب، وإنه كان على موعد مع علاج إشعاعي جديد بعد سلسلة من العلاجات الكيميائية القاسية، وإن مناعته في أدنى مستوياتها. هذه ليست تفاصيل ثانوية، بل جوهر القضية. لأن القانون الفلسطيني نفسه يمنع تسليم المواطنين إلى أي جهة أجنبية، فضلًا عن أن التسليم لرجل في وضع صحي هشّ يشبه الحكم عليه بالموت خارج وطنه. المحامي محمد الهريني قال بوضوح إن التسليم غير ممكن قانونيًا، وإن القضية ذات بعد سياسي لا مكان له داخل القضاء الفلسطيني. ثلاثة عشر مؤسسة حقوقية قالت الشيء نفسه، مؤكدة أن القرار انتهاك صارخ للقانون الأساسي، الذي نصّ بصراحة لا تقبل التأويل: لا يجوز تسليم أي فلسطيني إلى جهة أجنبية.
مع كل ذلك، تستمر السلطة في احتجازه بعد انتهاء مهلة الستين يومًا التي يمنحها القانون للموقوف. حيث لم تُصدر محكمة الصلح قرارًا واضحًا، ولم تُقدّم النيابة لائحة اتهام، ولم يُسمح له بالخروج للعلاج. وكل شيء يتقدم في مسار واحد: تنفيذ الطلب الفرنسي، مهما كان الثمن.
المفارقة التي تصفع وعي السلطة التي تستأسد على رجل مريض في زنازينها، ولا تجرؤ على اعتقال متعاون إسرائيلي او مستوطن واحد، ولا تستطيع حتى تنفيذ مذكرة توقيف دولية حققتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعة السابق . تلط السلطة التي تقدّم نفسها كدولة تلتزم بالقانون الدولي، تعجز عن تطبيق هذا القانون على الاحتلال، وتتفرغ لتطبيقه على أحد أبنائها من باب المسؤولية الدولية المشتركة. وكأنّ الدولة لم تُخلق لتحمي مواطنيها، بل لتسلّمهم عند الطلب .
هذه السابقة الخطيرة تعني أن السلطة مستعدة لتقديم أي فلسطيني، حتى لو كان مناضلًا عرفته الساحات قبل أن تعرف السلطة نفسها طريق المقاطعة. وتعني أيضًا أن أي عملية فدائية، مهما كان سياقها التاريخي، يمكن أن تُفتح من جديد إذا رغبت دولة أجنبية في ذلك. وتعني أخيرًا أن الفلسطيني أصبح مكشوفًا بالكامل، بلا حماية وطنية ولا غطاء سياسي، بل تحت رحمة قرارات فردية تُتخذ داخل مكتب مغلق.
هشام حرب ليس مجرد رجل مطلوب لفرنسا، بل هو عقدة سياسية تكشف طريقة تفكير السلطة: من السهل عليها أن تُظهر قوتها على الضعفاء، ومن المستحيل أن ترفع صوتها أمام قوة الاحتلال. لهذا يصبح تسليم الرجل “عربون شكر” سياسيًا أكثر مما هو تطبيق لقانون أو تعاون قضائي. فرنسا تريد إغلاق الملف، والسلطة تريد الاعتراف والدعم، ومن يدفع الثمن؟ رجل فلسطيني لم يعد يملك من حياته ما يشبه الحياة.
ما لا تريد السلطة الاعتراف به واقعيا أن تسليم هشام حرب ليس مجرد انحراف سياسي أو تجاوز قانوني بل هو إعلان خطير عن استعدادها للتخلي عن كل مناضل مرَّ يومًا عبر دروب المقاومة لتحرير فلسطين فإذا كانت باريس تستطيع اليوم أن تحرك مذكرة عمرها أربعة عقود وتجد في رام الله من يتسابق لتنفيذها فماذا سيحدث غدًا عندما تُعيد دول أخرى فتح ملفاتها الاخطر وما الذي سيمنع السلطة حينها من تحويل من تبقى من أبناء شعبها إلى قوائم قابلة للترحيل عند الطلب إنّ سابقة كهذه لا تُقاس بحجم رجل واحد بل بحجم شعب كامل يُدفع تدريجيًا نحو فقدان آخر مظاهر السيادة، وتتحول فيه السلطة من إطار وطني إلى مكتب اعتماد خارجي للتسليم والتنسيق وذلك هو الخطر الحقيقي ليس على هشام حرب وحده بل على معنى فلسطين نفسها .
قديماً كان الفدائي يخرج ولا يعرف إن كان سيعود. اليوم، يعود ليكتشف أن مصيره قد يُحسم في اجتماع مغلق أو اتصال عابر. هكذا وجد هشام حرب نفسه بطلَ رواية جديدة، لا تشبه أمجاد الماضي بقدر ما تشبه أرشيف الوعود التي تُقطع بسخاء وتُنفَّذ بندرة .
في النهاية، تبقى الحقيقة أن حركة تحرر وطني لا يمكن أن تبقى حركة تحرر إذا بدأت بتسليم المناضلين، وأن سلطة لا تحاسب مجرمي الحرب الإسرائيليين ولا تمنع اقتحامات جيشهم ومستوطنيهم لمدنها لن يصبح لديها فجأة القدرة على أن تكون دولة. القضية ليست هشام حرب وحده، بل السؤال الأكبر: ما قيمة السلطة إذا كان أضعف الناس تحت يدها هم أول من تسلّمهم، بينما أقوى أعدائها هم آخر من تجرؤ على الاقتراب منهم ؟
السؤال الذي لا يريد أحد في المقاطعة أن يسمعه: لو ظهر نتنياهو عند حاجز فلسطيني، هل تُنفّذ ضده مذكرة المحكمة الجنائية؟ أم أنه سيمشي كما مشى من قبله كل قادة الاحتلال، بينما تكمل السلطة إجراءات تسليم رجل فلسطيني إلى باريس في واحدة من أحلك اللحظات في تاريخها ؟
هكذا يصبح هشام حرب محطة حقيقية لكرامة السلطة وشرعيتها، وحدود قدرتها على حماية مواطنيها وبما يفضح دورها، ويكشف أن قرارها السياسي لم يعد يستند إلى أي رصيد وطني، بل إلى قائمة انتظار طويلة من الطلبات الأجنبية التي تجد من ينفذها بلا نقاش. وبينما تتكدس جثث غزة تحت الركام، وتتمرّغ المدن الفلسطينية بقهر الاحتلال، تظهر السلطة في مشهد لا يمكن وصفه إلا بالعار سلطة تلاحق المناضلين ولا تجرؤ على محاكمة إسرائيل .
كاتب وباحث مختص في الشؤون السياسية
[email protected]







