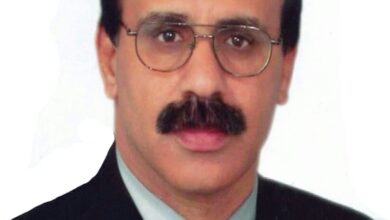التكثيف الحضري وضيق المساحات: بين السياسات المحلية وتهديد السلم المجتمعي والحلول

كتب أ.د. محمد الفرجات
في السنوات الأخيرة، اتجهت بعض السلطات المحلية في المدن الأردنية والعربية إلى تبني سياسات التكثيف الحضري عبر السماح بزيادة النسب الطابقية واستغلال الأراضي السكنية والتجارية بشكل أكبر في مساحات ضيقة. ورغم أن هذه السياسات تهدف في ظاهرها إلى تعظيم الاستفادة من الأرض ورفع قيمتها الاستثمارية، إلا أن انعكاساتها على الحياة اليومية والبيئة الاجتماعية قد تكون بالغة الخطورة إذا لم تُدار بعقلانية وتخطيط شمولي.
مبررات السلطات المحلية:
تسعى السلطات المحلية من خلال هذه السياسات إلى خفض الطلب على البنى التحتية والحد من المد العمراني والتوسع خارج التنظيم، في محاولة لوقف الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية والمناطق غير المخدومة. بيد أن هذه القرارات غالبًا ما تطبق داخل أحياء مُعدة ومُصممة أصلاً وفق مخططات استعمالات أراضٍ وتنظيم أبنية لكثافات سكانية معينة، ما يعني أن زيادة الارتفاعات والكثافة السكانية لا تتناسب مع الطاقة الاستيعابية الأصلية لهذه الأحياء.
ضغط على البنية التحتية:
إن رفع النسب الطابقية يعني بالضرورة زيادة عدد السكان والمستخدمين لمساحة محدودة من الأرض. هذا يضاعف الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، ويؤدي إلى أعطال متكررة وضعف في مستوى الخدمة. كما أن المدارس والمراكز الصحية والمرافق العامة لا تنمو بنفس الوتيرة، مما يخلق فجوات واضحة بين العرض والطلب.
أزمة المرور ومواقف السيارات:
من أبرز مظاهر هذا الضغط الحضري أزمة مواقف السيارات التي أصبحت سمة ملازمة للأحياء المكتظة. فمع تزايد الأبراج والعمارات السكنية دون توفير مواقف كافية، تضيق الشوارع بالسيارات المتوقفة عشوائياً، مما يعطل الحركة ويزيد من الحوادث المرورية والمشاحنات اليومية بين السكان. ضيق الشوارع في الأصل يفاقم المشكلة، ويحوّل حياة الناس إلى سلسلة من الصراعات اليومية على أبسط حقوقهم في الحركة والتنقل.
انعكاسات اجتماعية خطيرة:
لا يقف أثر التكثيف عند الجانب الخدمي والمروري، بل يمتد ليهدد السلم المجتمعي. فالتكدس السكاني في مساحات محدودة يخلق بيئة مشحونة بالتوتر والاحتكاك، ويزيد من احتمالية النزاعات بين الجيران، سواء حول مواقف السيارات أو الضوضاء أو الخدمات المشتركة. كما أن ضعف البنية التحتية يزيد من الإحساس بالظلم والتهميش، ويؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والسلطات المحلية.
وقد شهدت البلاد بالفعل تكرار مشاجرات خطيرة بسبب الخلاف على مواقف السيارات، تطورت في بعض الحالات إلى استخدام الأسلحة البيضاء أو النارية، وأفضت إلى وقوع قتلى وجرحى. هذه الأحداث المؤلمة تؤكد أن المسألة لم تعد مجرد إزعاج يومي، بل تحولت إلى تهديد مباشر للسلم الأهلي.
اختفاء الحدائق والمساحات العامة:
من أبرز سلبيات هذه السياسات أن الأبراج والعمارات تُبنى غالباً على حساب الحدائق والملاعب والساحات وممرات المشاة، وهي مساحات كان يفترض أن تُمثل متنفسًا حيويًا للأحياء. وبغيابها:
يُحرم الأطفال من أماكن آمنة للعب.
يُحرم الشباب من ملاعب ومرافق رياضية وثقافية تقيهم الانزلاق نحو السلوكيات السلبية.
يُحرم السكان من ساحات عامة للتواصل المجتمعي أو ممرات للمشي والرياضة.
وبذلك تتحول الأحياء إلى كتل إسمنتية صمّاء، تفتقر لأبسط مقومات الرفاه وجودة الحياة، فتزداد معدلات التوتر النفسي والاجتماعي.
البعد النفسي والتربوي:
الازدحام وضيق المساحات وفقدان المرافق العامة لا ينعكس فقط على البنية المادية للمدينة، بل يترك أثرًا عميقًا على الصحة النفسية والسلوك اليومي للسكان. فالأحياء المزدحمة ترتبط علميًا بزيادة معدلات الاكتئاب والعنف الأسري والاجتماعي، في حين أن الأحياء المتوازنة والمجهزة بحدائق ومساحات عامة ترفع مستوى السعادة والانتماء وتقلل من السلوك العدواني.
نحو سياسات حضرية متوازنة:
إن المطلوب ليس رفض فكرة التكثيف الحضري بالمطلق، فهي قد تكون ضرورة في بعض الحالات لمواجهة التوسع العمراني الأفقي واستهلاك الأراضي. لكن الحل يكمن في التخطيط المتوازن الذي يربط بين السماح بالارتفاعات والنسب الطابقية من جهة، وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة من جهة أخرى، مع الالتزام بتخصيص مساحات خضراء، ملاعب، ممرات مشاة، ومراكز ثقافية ضمن كل حي. فالتنمية الحضرية لا تعني فقط زيادة الأبنية، بل بناء حياة متكاملة تحترم حقوق السكان.
حين يشعر السكان أن أحيائهم تضيق عليهم وتفقد مقومات الراحة والعيش الكريم، تتزايد الاحتكاكات اليومية، ويضعف الإحساس بالانتماء للمكان، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي الذي يعتمد بالأساس على العدالة في توزيع الخدمات والمساحات.
حلول وتوجهات بديلة:
1. إعادة توزيع الكثافات:
بدلًا من تكثيف غير مدروس في الأحياء القائمة، يمكن توجيه التوسع الحضري نحو مناطق جديدة مخططة مسبقًا وفق معايير الاستدامة.
مثال: المدن الأوروبية تخصص “أحزمة نمو” جديدة تُبنى بكثافات مدروسة وخدمات مرافقة منذ البداية.
2. تخطيط حضري متوازن:
ربط أي زيادة في النسب الطابقية بزيادة مقابلة في مواقف السيارات، المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية.
مثال: في دبي، لا تُمنح بعض تراخيص الارتفاع إلا إذا التزم المطور العقاري بإنشاء حدائق أو ممرات مشاة عامة.
3. استخدام أنظمة النقل العام:
تطوير النقل الجماعي يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة، ويحد من أزمات الاصطفاف.
مثال: أنقرة وعمّان نفسها بدأت بمحاولات عبر الباص السريع (BRT)، ويمكن البناء عليها بتوسيع الشبكات.
4. تخصيص نسب دنيا للمساحات العامة:
فرض قانون يحدد أن لا يقل نصيب الفرد من الحدائق والساحات عن حد أدنى (مثلاً 9 م²/فرد كما أوصت منظمة الصحة العالمية).
مثال: سنغافورة طبقت مبدأ “المدينة الحديقة” حيث لا يقل غطاءها الأخضر للفرد عن المعدلات العالمية.
5. إشراك المجتمع المحلي:
إشراك السكان في صنع القرار العمراني عبر مجالس محلية فاعلة يضمن توافق السياسات مع احتياجاتهم الحقيقية.